تلخيص كتاب المراحل العمرية في التربية نظرة تأصيلية ومقارنة
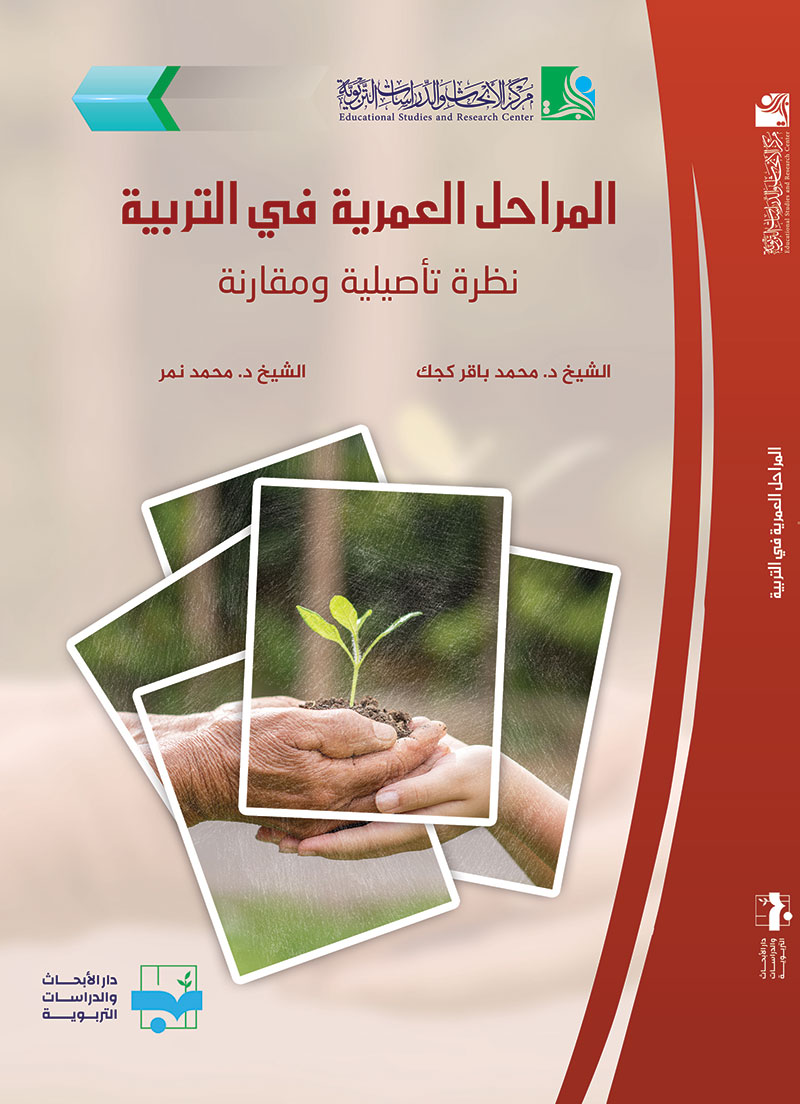


بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص كتاب المراحل العمرية في التربية نظرة تأصيلية ومقارنة،
تأليف:
الشيخ د. محمد باقر كجك- والشيخ د. محمد نمر.
كتابة وإعداد: الأستاذ أحمد مصطفى صالح
المقدّمة
إن التجربة العملية للتربية والتعليم في الميادين التربوية )المدرسة، الجامعة، الأسرة ...( أظهرت أن التيار السائد في التعامل مع المراحل العمرية المختلفة، وخصائصها النمائية، وأسلوب مواجهة المشكلات التربوية، كما أن منهج وضع الأهداف والكفايات التربوية الخاصة بها، تنبع في الحقيقة من الأسس العلمانية السائدة لعلم نفس النمو، حيث ركّز علماء نفس النمو على عمليّات وآليات العقل والسلوك بدلا من التركيز على العمر. لذلك، وانسجاما مع الهوية الحضارية والمعرفية الكبرى لحضارتنا الإيمانية والإسلامية الغنية بالنصوص القرآنية والروايات الشريفة الواردة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، وكذلك العقل الإسلامي المنفعل بالنص الديني التشريعي الذي أنتج العديد من التصورات التربوية الخاصة به، فإن النص الديني القرآني والروائي يمكن له بالاستقلال عن المدارس التربوية المعاصرة أو حتى تلك التي نمت في الفضاء الإسلامي، أن يقدّم نموذجا تأسيسيا فيما يخص المراحل العمرية وفق نظرة تأصيلية.
الفصل الأول: المراحل العمرية في القرآن الكريم.
أولا: مراحل الحياة الإنسانية في المنظور القرآني.
قسّم القرآن الكريم حياة الإنسان إلى ثلاثة مستويات عامة:
-1 الحياة في عالم ما قبل الولادة. أكّد القرآن الكريم أن حقيقة المقام الوجودي الأصيل للإنسان هو مقام الخلافة والولاية الإلهية، "وإذ قال ربُّك للملائكة إنين جاعل في الأرض خليفة"، وهذا المقام يستدعي تدخّلا خاصا من قبل الله تعالى في حياة الإنسان في أحد العوالم ما قبل الحياة الدنيا، "وإذ أخذ ربُّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنّا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنّما أشرك آباؤنا من قبل وكنّا ذرّية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصّل الآيات ولعلهم يرجعون". إن اصطلاح الميثاق الذي ذكرته الآية، يشكّل أوّل تدخّل معرفي تكويني في الحياة الإنسانية، وهو متماه مع الفطرة الإلهية التي تقتضي التوحيد. وفي الآية المذكورة هناك مجموعة من الإشارات لا بد من التنبيه عليها وهي:
-2 الحياة الدنيا.
-3 الحياة الآخرة.
ثانيا: مراحل الحياة في عالم الدّنيا من النّص القرآني.
بيّن القرآن الكريم بعض مواصفات الحياة الدنيا منها:
-1 الظرفية المؤقتة للحياة الدنيا: بمعنى أنها مكان زائل، "وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو".
-2 متاع الغرور: بمعنى أن زخارف الدنيا أحد موانع تكامل الإنسان المعنوي، "وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور".
-3 دار الغفلة: بمعنى أن الانجذاب نحو زخارف الدنيا يؤدي إلى الغفلة عن الآخرة، "يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون".
-4 الدنيا عرَض: بمعنى أنها موجود مت زلزل ومتبدل، "تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة".
-5 زينة الحياة: بمعنى أن زخارف الدنيا ما هي إلا زينة للحياة الدنيا، "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون".
والمقصود من حب الدنيا في هذا البحث هو ما يساوي العشق للدنيا التي تؤدي بالإنسان إلى الابتعاد عن الله، لا الاستفادة المعقولة من المواهب الطبيعية للتوصّل بها إلى الكمال المعنوي، حيث نجد تعبيرات إيجابية عن مواهب الدنيا منها: "ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض"، "يرسل السماء عليكم مدرارا"، "وعدكم الله مغانم كثيرة"، "قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطّيبات من الرّزق".
"يأيها النّاس إن كنتم في ريب مّن البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبيّن لكم ونقرُّ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمّى ثم نخرجكم طفلا ثمّ لتبلغوا أشدّكم ومنكم من يُتوفى ومنكم مّن يُردّ إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا".
-1 الترابية: العنصر الأساس الذي تتشكل منه أعضاء الجسم مصدره التراب.
-2 النطفة: تتألف من أحياء مجهولة مثيرة تسمّى عند الرجل الحويمن وعند المرأة البويضة.
-3 الجنين: يصبح الجنين علقة، وتكون خلاياه كحبات التوت بشكل قطعة دم خاثر متلاصقة.
-4 المضغة: يتّخذ الجنين شكل قطعة لحم، دون أن تتضح معالم الأعضاء فيه، ويسقط كل جنين
لا يمكنه العبور بهذه المرحلة، ويمكن أن تكون عبارة "مخلّقة وغير مخلّقة" إشارة إلى هذه المرحلة.
-5 الطفل.
-6 البلوغ.
-7 الشيخوخة.
ب تفسير خسرو باقري للمراحل الثلاث من القرآن -
ينطلق خسرو باقري في بحثه حول المراحل العمرية من قوله تعالى"الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل
من بعد ضعف قوّة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير".
مرحلة الضعف الأولى )الطفولة(
قام خسرو باقري بتقسيم فرعي لهذا الأصل بناءً على الروايات على الرغم من أن الآية ظاهرة في العموم
من تقسيمها للمراحل الثلاثة، ولا يمكن بحال أن يتمّ تفسيرها كما فعل خسرو بالروايات دون وجود
قرينة. ومع ذلك، يرى باقري أنه يمكن تقسيم هذه المرحلة كالتالي:
-1 مرحلة النشاط: وتشمل السنوات السبع الأولى من عمر الإنسان.
-2 مرحلة حصول قابلية التعلّم والتأديب: مع بداية السنة السابعة تظهر خصلة جديدة في الطفل وهي تقبّل التكليف، ويتمتّع الطفل بقابلية استقبال التكليف التعليمي والتأديبي. ومن الخصال المهمة الأخرى في هذه المرحلة ظهور القابلية الكافية لمعرفة الاختلافات الجنسية بين الجنسين وإدراك مسألة الهوية الجنسية له وللآخرين.
مرحلة القوة )البلوغ وذروة البلوغ(
-1 مرحلة البلوغ وذروة البلوغ: بعد المرحلة السابقة عند العاشرة من العمر تتو فّر . استعدادات في الفرد تختتم بالبلوغ الجنسي أو بلوغ النكاح، أي تتهيأ لديه مقتضيات الزواج، هذا ما يسمى بالبلوغ. أما ذروة البلوغ، فتظهر لدى الفرد مع نهاية العقد الثاني، وهي تتمثّل بالرشد وبلوغ الأشدّ ، حيث ينال الفرد القابلية الفكرية والاجتماعية "فإن آنستم منهم رشدا"، "يبلغا أشدهما".
-2 مرحلة الاعتدال: "ولما بلغ أشدّه واستوى آتيناه حكما وعلما"، الاستواء بمعنى الاستقرار والاعتدال، حيث تبدأ مرحلة الثبات والاستقامة والوصول إلى نوع من الاستقرار في الحالات الفكرية والعاطفية والاجتماعية، ومحلّ ظهورها هو العقد الثالث من عمر الإنسان.
-3 مرحلة الاعتلاء: في هذه المرحلة تنتظم الصراعات الداخلية ويتمّ ضبطها، وتتوفّر الأرضية المناسبة لحصول أفكار وقرارات أكثر عقلانية، ويكون ذلك في العقد الرابع من العمر. "حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذرّيتي".
مرحلة الضعف النهائي )الكهولة والشيخوخة(
-1 مرحلة الكهولة: تبدأ في العقد الخامس وتنتهي في العقد الثامن. يبدأ الضعف في القوى الجسمية بالظهور تدريجيا، ومن الناحية العقلية، تعتبر المرحلة الحالية مرحلة إعطاء الثمر.
-2 مرحلة الشيخوخة )أرذل العمر(: تبدأ مع العقد الثامن وتستمر إلى ما بعد ذلك، وتترافق مع ضعف ووهن كامل.
تقييم لطرح خسرو باقري
لم يراع باقري الدقة المنهجية في استنطاق الآيات القرآنية، واعتمد منهج تلفيقي جمع فيه بين إضافات النص الروائي وتحليله الشخصي، واختياره لنصوص روائية دون غيرها مع عدم النقاش في حجية سندها،
يفضي إلى عدم التسليم بالنتائج التي وصل إليها.
ت المراحل الأربعة للحياة الإنسانية من وجهة نظر العلامة الطباطبائي -
تعتمد رؤية العلامة الطباطبائي على الآية الكريمة "يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربّكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين".
-1 الموعظة: يعتبر العلامة أن أول مرحلة من الحياة الإيمانية قائمة على عملية إيقاظ المؤمنين من بحر الغفلة، فالموعظة الحسنة تنظف باطنه وترشده إلى لخير.
-2 الشفاء: وهي مرحلة تنظيف باطن الإنسان من كل صفة خبيثة وقبيحة وبشكل دائم.
-3 الهداية: يتم خلالها سوق الإنسان إلى المعارف الحقة والأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة.
-4 الرحمة: يفسّر العلامة الرحمة بأنها إفاضة يتم من خلالها جبران النقص وسد الحوائج.
تقييم لطرح العلامة الطباطبائي
يمتاز طرح العلامة بالأصالة الإسلامية نظرا لكونها مستقاة من الكتاب الإلهي، إلا أن تقديمها كطرح مواز لمسألة المراحل العمرية هل يمكن اعتبار المرحلة الأولى مثلا تناسب مرحلة الطفولة المبكرة؟، يشوبها –
شيء من عدم الوضوح والربط المنهجي، لكنها تبقى صالحة لاستخلاص الأصول العامة للتربية.
ث. المراحل العمرية عند الشيخ المصباح اليزدي -
يعرّف الشيخ المصباح المراحل العمرية بأنها نشاطات التعليم والتربية التي يكون لكل واحد منها دائرة
محدودة والتي تقع في طول بعضها البعض من حيث الزمان وهي مترتبة على بعضها البعض وناظرة إلى
الظروف والخصائص المادية. ومع ذلك، فإن تحديد مراحل التربية والتعليم يرتبط بالد راسات التجريبية.
وهو يرى أن لفلسفة التربية والتعليم دورها ليس في تعيين هذه المراحل، بل في تعيين المعايير العقلية التي
تسمح بتحديد المراحل العمرية. وعليه، هذه النظرة التي تبناها الشيخ المصباح لم يتم من خلالها تحديد
تقسيم عمري واضح لها، وما تم التوصّل إليه هو عرضه لرؤية قرآنية متكاملة حول المراحل العمرية بناءً
للنصوص القرآنية حصرا.
ثالثا: مراحل حياة الإنسان ما بعد الحياة الدنيا.
تقوم النظرة الإسلامية على قطعيّة الحياة بعد الموت، وأنّ عالم ما بعد الموت، مبتن بشكل دقيق على
طبيعة الحياة التي يعيشها الفرد في الحياة الدنيا.
أ. الموت في اللغة والقرآن: الموت في اللغة هو ذهاب القوّة من الشيء. أما القرآن فاعتبر الموت انتقالا من عالم إلى عالم آخر، "ثم قضى أجلا وأجلٌ مسمى عنده"، إن الأجل المسمى هو من عند الله وهو أمر إلهي، وعند الله يعني أنه ثابت ومصون من كل تأثير.
ب. الموت يكشف الحقيقة للإنسان: إن الحياة الآخرة هي ظرف الفعلية التامة وظهور كافة الأفعال والأعمال على ما هي عليه في الحقيقة. فإن نفس الإنسان سينكشف لها حقيقة ما كانت عليه في الدنيا.
ت. معالم هامة للحياة بعد الموت : فقدان النفس لصفة الاختيار، الجزاء، حتمية أخروية الجزاء، ضرورة الاعتقاد بالآخرة، وجود الآخرة موافق لضرورة العقل والبرهان، الخلود، الفصل بين المحسنين والمسيئين.
ث. أهمية الإيمان بالمعاد والآخرة: على مستوى الحياة الفردية، إن لتحديد الهدف النهائي للحياة الدور الكبير في توجيه بوصلة الإنسان، فالمؤمن بوجود عالم آخر لا يحصر الحياة ببعدها المادي. وكذلك على مستوى الحياة الاجتماعية، فلإيمان الفرد بوجود عالم آخر دورا مهما في تحديد نوع العلاقة الاجتماعية بين الأفراد.
الفصل الثاني: تقسيم مراحل التربية بحسب الروايات
I . تقسيم المراحل العمرية بحسب الروايات الصريحة
السلام قال:دع ابنك يلعب سبع سنين، وألزمه نفسك سبعا، فإنّ أفلح وإلّا فإنه ممّن لا خير فيه.
المعالجة السندية: هذه الرواية منقولة عن رجل مجهول لذا فالخبر غير معتبر السند، ولكن يمكن
جعلها مقبولة بناءً على ورودها في الكافي من دون الاعتماد عليها في تأسيس نظريات تربوية.
.2 الرواية الثانية: صحيحة يعقوب بن سالم: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الغلام يلعب سبع سنين، ويتعلّم الكتاب سبع سنين، ويتعلّم الحلال والحرام سبع سنين.
هذه الرواية هي العمدة في التقسيم الثلاثي للمراحل.
.3 الرواية الثالثة: مرسلة الصدوق: قال الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدب
سبع سنين، وألزمه نفسك سبع سنين، فإنّ أفلح وإلا فإنه ممّن لا خير فيه.
المعالجة السندية: هذه الرواية مرسلة وضعيفة على المشهور، ولكن الكثير من علمائنا حلوا
مشكلة مراسيل الصدوق وصححوها إما بمعنى الصحة السندية أو الاعتبار، ومنهم الإمام الخميني قدس سره والسيد الخوئي رحمه الله حيث صحح جملة كبيرة منها إذا كانت تبتدئ بلفظ قال، وعليه تكون الرواية معتبرة.
.4 الرواية الرابعة: خبر يونس بن يعقوب: عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين، ثم ضمه إليك سبع سنين، فأدبه بأدبك، فإنّ قبل وصلح، وإلا فخلّ عنه.
المعالجة السندية: هذه الرواية مبتلاة بالإرسال والضعف، ولا مجال لتصحيحها واعتبارها.
.5 الرواية الخامسة: خبر عبدالله بن فضالة: عن أبي عبدالله أو أبي جعفر عليهما السلام قال يقول: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات: قل لا إله إلا الله، ثم يترك، حتى يتمّ له ثلاث سنين وسبعة أشهر فيقال له: قل محمد رسول الله سبع مرات )إلى آخر الرواية(.
المعالجة السندية: هذه الرواية ضعيفة السند ، ولكن يمكن الاعتماد عليها في التطبيقات.
.6 الرواية السادسة: مرسلة الصدوق: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يُربّّ الصبي سبعا، ويؤدّب سبعا، ويستخدم سبعا، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في خمس وثلاثين سنة وما كان بعد ذلك فبالتجارب.
المعالجة السندية: هي من المراسيل التي يمكن تصحيحها لأن الصدوق عبّر بكلمة قال.
.7 الرواية السابعة: مرسلة الطبرسي: نقلها الطبرسي عن المحدّث الجليل أبي جعفر البرقي عنه عليه السلام قال: احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين، ثم أدّبه في الكتاب ست سنين، ثم ضمّه إليك سبع سنين فأدّبه بأدبك، فإنّ قبل وصلح وإلا فخلّ عنه.
المعالجة السندية: هي رواية ضعيفة غير معتبرة.
.8 الرواية الثامنة: المرسل الآخر للطبرسي: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد سيد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين، فإنّ رضيت أخلاقه لإحدى وعشرين، وإلا فاضرب على جنبه، فقد أعذرت إلى الله تعالى.
المعالجة السندية: الرواية لا سند لها في مصادرنا ولا يمكن اعتبارها.
المعالجة الدلالية )الروايات المعتبرة فقط( .II
الرواية الثانية: تشير الرواية إلى ترك الولد وعدم إثقاله بالتعليم إلى عمر سبع سنين، ولا يفرض ذلك ترك تأديبه بل ترك تعليمه، حيث يبدأ بتعلم القراءة والكتابة من سنّ السابعة، ولا يقتصر التعليم على القرآن الكريم حصرا، بل باعتباره المصدر المعرفي الإيماني الأول للإنسان، حيث يعتبر الإسلام العلم فريضة على
كل مسلم ومسلمة، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: مروا أولادكم بطلب العلم، فيما يتمّ الشروع بتعليمه الحلال والحرام في سنّ الرابعة عشر لأنه يكون قد بلغ سن التكليف الشرعي. وقد اعتبر صاحب
الوسائل أن التربية والتعليم كانا متلازمين في ذلك العصر، فتكون الرواية تتكلم عن فضاءات التربية وليس
التعليم فقط، فتكون المراحل بحسب هذه الرواية: ترك فتربية وتعليم للكتابة والقرآن وتربية وتعليم للحلال
والحرام.
الرواية الثالثة: تنسجم هذه الرواية مع الرواية الثانية حتى أنه بعد أن ثبتنا اعتبارها ا وحتمال كونها رواية واحدة قد أسقط منها مرحلة من المراحل في مرسلة يونس، فتكون هذه الرواية هي المعتبرة في الاستدلال.
الرواية السادسة: مضمون الرواية واضح، غير أنه يضع مفهوم الاستخدام بدلا عن مفهوم اللزوم. هنا عدة نقاط عن مجمل الروايات:
.1 أغلب الروايات تستخدم تعبير الصبي دون الصبية، ولعله لشيوع التعبير لا لخصوصية الذكورة، ففي مجال التربية بشكل عام لا يوجد خصوصية لكل منهما، أما لحاظ الفروقات الجنسية فموكول لروايات أخرى، وعليه يمكن تأسيس قاعدة عامة إسلامية لها علاقة بتقسيم المراحل العمرية لكلا الجنسين.
.2 إن موضوع ترك الولد يلعب سبعا لا يعني عدم الاهتمام به بالمرّة، بل المراد الإشارة إلى الطابع العام لهذه المرحلة، وهو طابع عدم تحميله المسؤوليات.
.3 الشيء الذي نستنتجه بوصفه قاتها مشتركا بين الروايات هو:
ولذا يمكن تقسيم المراحل كالتالي:
- المرحلة الأولى: لعب وترك.
- المرحلة الثانية: تأديب وتربية.
- المرحلة الثالثة: مصاحبة ومؤازرة واستخدام.
وفي الخلاصة تؤكد الروايات الثمانية على التالي:
- إن التقسيم المراحلي لعمر الإنسان هو حقيقة شرعية ثابتة.
- إن الروايات الصحيحة والمعتبرة في هذه المسألة وإن كانت قليلة، فهي كافية لإثبات إرادة الشارع في التأسيس الشرعي لقضية المراحل العمرية.
- إن الاختلافات الموجودة في الحدود العمرية للمراحل لا تلغي أصل التقسيم.
III . تقسيم المراحل العمرية بحسب الفهم الإجمالي للطرح القائم على الروايات
)1-7 سنوات – مرحلة الطفولة المبكرة )
مراحل الطفولة في الرؤية الإسلامية
إن التأكيد على لَعبية مرحلة الطفولة لدى الإنسان يعني بوضوح عدم القدرة على أن نكسب الطفل
تجاربه العقلية أي طابع من الثبات، لبداهة أنّ نموه العقلي لا يتناسب مع أية تجربة تربوية جادة تتطلب
قدرا من النضج لا تتحمله مرحلة نماء الطفل. وهذا التأكيد يفصح بوضوح عن خطأ أية نظرية تضفي على الطفولة خطورة تربوية ذات أبعاد. وقد لجأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاستعارة لكي يوضّح لنا ما يعنيه من مفهوم لَعبية هذه المرحلة، حيث يقول: الولد سيد سبع سنين، أي أنه لا يتلقّى الأوامر من أحد، بل يتّجه إلى ممارسة نشاطه بحرّية، بعكس المرحلة الثانية التي عبّر عنها بقوله: وعبد سبع سنين، يتلقّى الأوامر ويُطالب بتنفيذها، أي بمعنى أنه مهيّأ لعملية التدريب والتربية، أما قوله: ووزير سبع سنين،
فهي مرحلة المراهقة.
مراحل الطفولة في رواية الإمام الصادق عليه السلام
يُروى عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين، يقال له قل سبع مرات لا إله
إلا الله، ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له: قل محمد رسول الله سبع مرات، ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له سبع مرات: اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له: أيهما يمينك وأيهما شمالك؟ فإذا عرف ذلك وجهه إلى القبلة ويقال له اسجد، ثم يترك حتى يتم له ست سنين، فإذا تم له ست سنين صلى، وعلّم الركوع والسجود حتى يتم
له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له: صلّي حتى يتم
له تسعة، فإذا تمت علّم الوضوء وضرب عليه وعلّم الصلاة وضرب عليها.
يمثّل هذا النص مادّة تربوية مستوعبة لكل مراحل النّماء العقلي عبر الطفولتين المبكرة والمتأخرة، ولعلّ أوّل ما ينبغي أن نلاحظه في هذا المجال هو العبارات التي استخدمها الإمام الصادق عليه السلام ثم الأفعال التي طالب الطفل القيام بها. إن طلب الإمام من الطفل قول لا إله إلا الله في سن الثالثة هو حسمٌ من قبل المشرّع بقابلية التعلّم الرمزي في هذا السن، ومن ثم انتقاله إلى مرحلة نمائية جديدة تسمح له بإدراك العلاقة بين الله سبحانه ورسوله الأكرم، فيطلب منه قول محمد رسول الله كرسول لا كشخص، لقدرته –
على إحداث علاقة بين ظاهرتين تستندان إلى الرمز، بعد أن كانت قدرته تقتصر على الربط بين ظاهرتين إحداهما حسية وهي خبراته في سنينه الثلاثة، والأخرى تجريدية وهي لفت ذهنه إلى عبارة الله.
الطفل في السنة الرابعة
يطالب النّص الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام بتدريب الطفل على عبارة اللهم صل على محمد وآل محمد، وهذا تطوّر جديد قائم على حذف العلاقة القديمة أساسا وإدراك شخصية محمد بنحو مستقل دون استحضار الأطراف السابقة.
الطفل في السنة الخامسة
قدّم الإمام الصادق معيارا لدخول الطفل إلى عتبة المرحلة المتأخرة من الطفولة، وهو إمكانية إجابة الطفل
على سؤال سهل ولكنه في غاية الأهمية ألا وهو أيهما يمينك من شمالك؟، من دون أن يكلّفه بالصلاة كما جرى الأمر مع من هم في سن السادسة، بل اكتفى بالطلب منه بالسجود.
ما هو معيار التفاوت بين الخامسة والسادسة والسابعة؟
إن السادسة والسابعة تمثّل كل منهما مرحلة من النماء لدى الطفل، ولا ينحصر الأمر بالخامسة، إلا أنّ
السادسة تظلّ هي المعيار في بلوغ النمو مرحلته التي ترشّح الطفل لعملية التعلّم الجدّي للصلاة، ولكنه لا
يزال يشكل عملية غير مكتملة إذ أن الصلاة تحتاج للوضوء لتكتمل وهو ما طلبه الإمام في سن السابعة،
التي يمكن اعتبارها عتبة الدخول إلى مرحلة التأديب والتعلّم.
أولا: التمييز لغة واصطلاحا
- التمييز في اللغة هو عزل الشيء وفرزه، ويكون بين المشتبهات والمختلطات من الأمور.
- التمييز في الاصطلاح: ذكر بعض الفقهاء أنه التمييز بين الحسن والقبيح وفهم ما يفهمه الكبار، وقال بعض آخر أن الطفل يكون مميّزا بمعرفته وظيفة الأعضاء التناسلية.
وعليه، لا يمكن إعطاء تحديد زمني دقيق لبداية مرحلة التمييز، لأنه خاضع لجملة من العوامل الاجتماعية
والتربوية، ولنباهة بعض الأطفال، بحيث أنها لا تقل عن السادسة ولا تزيد عن السابعة من عمره. فالمراد
إجمالا من الصبي المميّز هو أن يصير له وعي وإدراك يفهم به الخطاب الشرعي، فيدرك معاني العبادات
والمعاملات ولو بصورة سطحية. أما نهاية مرحلة التمييز فهي بالتأكيد بداية مرحلة البلوغ.
ثانيا: خصوصية دخول الطفل في سن السابعة
إنّ لسن السابعة ميّزة خاصة في النصوص الدينية كونها تتيح فرصة تنمية البعد المعرفي في شخصية الطفل، فعن الأمير عليه السلام: قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها شيء إلا قبلته. إضافة على ذلك، تتجاوز النصوص الشريفة الميدان المعرفي إلى الميدان الحس حركي، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: -
علّموا أولادكم السباحة والرماية، وذلك لكي يستثمرهما الصبي لاحقا في اكتشاف نفسه وفي الدفاع عن
الأمة الإسلامية، فضلا عن التشدد في التدريب على عملية الصلاة كما مرّ في رواية الإمام الصادق عليه
السلام وضربهم عليها. بناءً عليه، نلاحظ الدكتور البستاني يشير إلى جملة من الحقائق منها:
- إن التمييز في عملية الإدراك عند أطفال هذه المرحلة يشكّل طابعا ملحوظا في هذا الميدان.
- إن الإلزام أو الجبر يشكل بدوره طابعا في عملية التدريب.
- التأديب البدني بمقدار أولي، عبارة عن واحدة من طرائق التنشئة في هذه المرحلة.
هنا نجد أن ظاهرة التّمييز عند أطفال هذه المرحلة لا تكتسب درجة الثبات التّامة، أي أنه تمييز متوسط،
لا يحمل إهمال المرحلة الأولى، ولا إلزام المرحلة اللاحقة. ففي التعامل الاقتصادي، يقول الإمام الباقر عليه
السلام: الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، وهو نهي صريح، بينما يقول النبي الأكرم: الصغير الذي لا
يحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سرق، وهنا تحفّظ متوقف على إتقان الطفل لحرفته في التعامل معه من
عدمه. وبعيدا عن التحفّظ السابق، يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت
وصيته، بل حتى في السابعة من العمر إذا أوصى باليسير من أمواله، يقول عليه السلام: إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
ما نستخلصه من مجمل الروايات من حقائق هو:
- انعكاس التنشئة للطفل في هذه المرحلة على شخصيته لاحقا.
- ظهور الدافع الجنسي وخطورته في هذه المرحلة.
- تميز الدافع الجنسي عن الدوافع الأخرى من حيث ظهوره.
- اضطراد هذا الدافع مع نمو الجانب المعرفي للطفل.
محددات سنّ التمييز في التربية الجنسية
عن الإمام الصادق عليه السلام: الغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين، وهذا يعني أن الطابع الجنسي
يستيقظ بشكل خاص عند الطفل البالغ سبعة. وعنه عليه السلام: الصبي والصبي، والصبي والصبية،
والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين، بل في رواية أخرى لست سنين، أي مع بداية
مرحلة التمييز. إضافة إلى ذلك، يتجاوز المشرّع الإسلامي هذه المنبهات إلى المنبهات الجنسية العاديّة، كالإطلاع بشكل أو بآخر على الممارسة بين الأبوين، بل حتى استشفاف ذلك من خلال نفسهما عبر
التواصل الجنسي أو الممارسة الجنسية. فالتّمييز فيما يتّصل بالدافع الجنسي يبلغ درجته العالية إذا قورن بالدافع إلى المال مثلا، حيث نرى المشرّع يحظر كل أنماط التعامل الجنسي بدون أي تحفّظ كما جرى في
الموضوع المالي، وذلك لما له من أثر بالغ الخطورة من حيث انعكاساته على شخصية الطفل لاحقا.
ومن الروايات التي تساعد على هذا الاتجاه في تحديد سن التمييز لخصوصية السلوكيات الجنسية:
- عن أبي عبدالله عليه السلام: إذا بلغت الجارية الحرّة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
عن الرضا عليه السلام أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل خمس، فنحاها عنه.
- عن الباقر عليه السلام: قال علي عليه السلام: مباشرة أي مس أعضائها أثناء التطهير أو الاستحمام أو التنظيف المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا.
ثالثا: تطبيقات في سن التمييز
-1 أهلية الصبي المميّز لقبول الإسلام منه:
- القول الأول: أنه يحكم بإسلامه إذا أقر بالشهادتين وأظهر الإسلام ويخ جر بذلك عن تبعيته للأبوين الكافرين. ودلالة هذا القول هو بأن الإسلام يدور مدار الإقرار بالشهادتين دون التفريق بين البالغ وغيره.
- القول الثاني: أنه لا يحكم بإسلامه، بل يتبع أبويه في الحكم بكفره إذا كانا كافرين. ودلالة هذا القول أنه لا اجتهاد مقابل النص الذي يقول برفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، دون التفريق بين الواجبات الأصولية والفرعية.
-2 أهليته للعبادات
عن الإمام الصادق عليه السلام: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين. فالمشهور بين العلماء أن عبادات الصبي شرعية وليست تمرينية، وبيان ذلك أن العبادات إما واجبة أو مستحبة.
أدلتها له كشمولها للبالغين.
- العبادات الواجبة: أدلّتها شاملة للصبي المميّز إلا أن حديث رفع القلم حاكم عليها، والمراد من رفع القلم إما قلم المؤاخذة، بحيث لا يؤاخذ بترك الواجبات وفعل المحرمات، أو قلم التكاليف التي يترتب على مخالفتها المؤاخذة، ومعنى ذلك أنه خُصّصت التكاليف بما عداه فعلى هذا يكون الصبي خارجا عن موضوع أدلّة التكاليف، ولكن يدلّ على مشروعيتها له.
-3 أهليته للمعاملات
بحث الفقهاء في أهلية الصبي المميّز لإيقاع المعاملات لنفسه أو لغيره في كلتا الحالتين، بإذن الولي أو بدونه. وإن القول بتأثير إجازة الصبي بعد البلوغ في تصحيح معاملاته الواقعة قبل بلوغه يبتني على القول بعدم اعتبار كلامه قبل البلوغ، إما لأنه لا اعتبار لأقواله وأفعاله، وإما لوجود العيب في عقده الذي يقتضي قيام الولي في المعاملات أو إشرافه على الأقل.
معايير تحديد مرحلة التمييز
-1 7 سنوات حتى البلوغ: وقد تبنّى غالبية الفقهاء المعيار الزمني لتحديد مرحلة التمييز، ولعلّ منشأ ذلك عندهم هو الروايات التي تفيد كون سن ال 7 يشكّل مرحلة جديدة لها مستلزمات خاصة في حياة الطفل.
-2 معرفة الحسن من القبح: وقد تبنّى هذا المعيار جملة من الفقهاء منهم الشيخ الأراكي فقال: المميّز هو القادر على التف رقة بين القبيح والحسن. وليس المراد التفرقة بشكل تفصيلي إنما بشكل إجمالي.
-3 مرجعية النظرة العرفية: قال السيد محمد جواد العاملي: المرجع في المميّز إلى العرف، لأنه المحكّم في مثله.
-4 اختلاف التمييز باختلاف متعلّق التكليف: يجيب السيد السيستاني حفظه الله على سؤال عن ضابط الصبي المميز في بعض المواضع بأنه يختلف باختلاف التكليف.
-5 اختلاف المميز باختلاف الزمان والمكان والأفراد: وهو رأي الإمام الخامنئي دام ظله الذي يقول بأن سن التمييز مختلف تبعا لاختلاف الأشخاص في الاستعداد والإدراك والذكاء.
الاستنتاج
إن ما تقدّم من أقوال الفقهاء ليس معايير متعددة، وإنما هو معيار واحد تم تسليط الضوء عليه من زوايا
مختلفة، وهو أن يصل الطفل إلى مرحلة عمرية تُصبح لديه ملكة التمييز بنحو إجمالي بين الحسن والقبيح.
وعليه، فإن الضابط الكلّي لتحديد التمييز ليس زمانيا بل معرفيّ، إلا في المعيار الأول من باب التعبّد
بالنّص الشرعي، بغضّ النظر عن الحالة المعرفية لابن السبع سنوات.
)3 المرحلة الثالثة: مرحلة البلوغ والمراهقة
حدّد المشرّع الإسلامي بداية مرحلة الرشد في الخامسة عشر فصاعدا، وتترتب على هذه المرحلة آثار
العقاب والثواب، بخلاف الاتجاهات التّربوية المعاصرة التي تعتبر سن الثامنة عشر هو سن الرّشد دون
ترتيب أي مسؤوليات عليه قبل هذا العمر.
أولا: البلوغ لغة
- المعنى الأول: الوصول.
- المعنى الثاني: الإدراك.
الظاهر أن كلا المعنيين يدلان على ما نحن فيه، فالأول يعني الوصول إلى النضج الجنسي، والثاني يعني
الإدراك العقلي، ويمكن الجمع بينهما بأن نقول بأن كل واحد منهما يشير إلى البلوغ الشرعي، وأن الطفل الواصل إلى مرحلة النضج الجنسي تنضج مداركه ويبدأ بدرك الأشياء وفهمها فهما أعمق.
ثانيا: البلوغ اصطلاحا
يتحدّد البلوغ بمن بلغ الحلم ووصل إلى حدّ النكاح.
ثالثا: البلوغ حالة تكوينية والتكليف حقيقة شرعية
إن البلوغ حالة تكوينية حقيقية ينتقل فيها الإنسان من الطفولة إلى الرجولة لدى الذكور أو إلى مرحلة
النساء لدى الإناث قهرا، فإن وصل الإنسان إلى هذه المرحلة تكوينا يبدأ الشارع المقدّس بتكليفه.
IV . اتجاهات روائية ثلاثة لسن البلوغ عند الذكور
أولا: سن الثلاثة عشرة: يقول الإمام المعصوم عليه السلام: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له
الحسنة وكتبت له السيئة وعوقب. يقرّر النص هنا أن سن البلوغ هو الثالث عشر بدليل كتابة الحسنة
والسيئة.
ثانيا: بين الثلاثة عشرة والرابعة عشرة: يقول الإمام المعصوم عليه السلام وقد سئل: في كم تجري
الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة وأربع عشرة. هذا التراوح بين العامين هو حسب التفاوت
في ال نّمو لدى الأفراد.
ثالثا: سن الخامسة عشرة: يقول الإمام المعصوم عليه السلام: الغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا
يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة. وهو يمثّل العمر المتأخر للبلوغ.
تقسيم مراحل البلوغ
-1 المرحلة المبكرة أو المراهقة المبكرة، تبدأ من العام الثالث عشر إلى العام السادس عشر، وقد يتّفق الباحثون والتربويون وعلماء النفس على أن فترة المراهقة تبدأ من البلوغ الجنسي.
-2 الم راهقة المتأخرة تبدأ من العام السابع عشر إلى العام الواحد والعشرين، ويختلف علماء النفس والتّربية على انتهاء هذه المرحلة اختلافا شديدا.
يشير أمير المؤمنين عليه السلام إلى فارق النمو بين هاتين المرحلتين بقوله: لا يزال العقل والحمق يتغالبان
على الرجل إلى ثمان عشرة سنة فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما فيه. وهذا لا يعني توقف العقل عن النماء
عند هذا العمر، حيث يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلا التجارب، فعلى
الرغم من تحديد نهاية النماء العقلي عند هذا السن، إلا أنه استثنى التجارب التي تساهم بلا شك في
إذكاء المهارة العقلية.
أما ما ورد في الروايات عن تحديد عمر الثالث والثلاثين والخامس والثلاثين والأربعين والخامسة ا ولستين،
ومنها عن الإمام الصادق عليه السلام: يزيد عقل الرجل بعد الأربعين إلى خمسة وستين ثم ينقص بعد
ذلك، فهو في الحقيقة مراحل النضج العقلي وليس النماء العقلي.
بلوغ النضج في النّص الشرعي
.1 يعتبر سن الثامنة عشرة حاتها في تحديد المسار التربوي للفرد، فإما تهيمن عليه القوى العقلية وإما
يسقط في دوامة الشهوات.
.2 يعتبر عمر 28 سن توقف النمو العقلي إلا ما يأتي عن طريق التجارب.
.3 يعتبر عمر 66 بداية ضمور قوة العقل بشكل عام، إلا أن الروايات صرّحت بإمكانية بقاء العقل
شابا وقويا في سن الشيخوخة.
V . البلوغ عند الفتيات
الرأي الأول: بلوغ الأنثى بتسع سنوات. وهو قول مشهور الفقهاء، عن أبي عبدالله عليه السلام: حدّ
بلوغ المرأة تسع سنين، والروايات في هذا الرأي كثيرة.
الرأي الثاني: بلوغ الأنثى بثلاث عشرة سنة. موثّقة عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: ... والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو
حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة، وجرى عليها القلم.
الرأي الثالث: بلوغ الأنثى يكون بالطمث والحيض. لا خلاف بين الفقهاء في دلالة الحيض على
البلوغ، والمشهور أن الحيض دليل على سبق البلوغ لا أنه البلوغ بنفسه. ويدلّ عليه مجموعة من الروايات،
منها عن أبي عبدالله عليه السلام: وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض لتسع سنين.
والتعليل ب )لأنها( يوحي بأن المناط هو الحيضية لا السن. ومنها أيضا ما جاء في موثوقة إسحاق بن
عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: الجارية عليها الحج إذا
طمثت، والدلالة واضحة بوجوب الحج عليها من خلال طمثها.
الرأي الرابع: البلوغ عند الأنثى حسب اختلاف الأحكام. ذكر المحدّث الكاشاني هذا الرأي من باب
التوفيق بين الأخبار، حيث جاء أن الصيام لا يجب على الأنثى قبل إكمالها 13 سنة إلّا إذا حاضت،
والحدود لا تؤاخذ بها إلا إذا أكملت 9 سنين، أما الوصية فإنها تصح من ذي 16 سنين. كما ذكر
المحدّ ث البحراني أنه لا يبعد عنده الجمع بين الأخبار حمل ما دلّ على البلوغ بخمس عشرة على الحدود
وما دونه على العبادات. وقد أجيب عن هذا الكلام بأنه مخالف لإجماع الإمامية، بل المسلمين.
الخلاصة: المشهور في تحديد سن بلوغ الأنثى هو تسع سنوات وهناك محاولات للجمع العرفي بين
الروايات المتعارضة من أجل تحديد سن بلوغ الأنثى ب 13 سنة أو إذا حاضت قبلها أو احتلمت أو
نبت الشعر الخشن على العانة. ومع أنّنا نلتزم الرأي المشهور، إلا أن روايات تحديد البلوغ أو الأمر
بالصلاة يمكن أن تكون مؤشرا على مدى تسامح الشريعة في كيفية تربية البنت من الناحية التربوية وكيفية تعامل الأهل مع التدرّج في عدم التساهل في جزئيات العبادات.
الفصل الثالث: نظريات مراحل النمو عند مفكري المسلمين )نماذج مختارة(
I . المراحل العمرية في رسائل إخوان الصفا.
.1 36 سنة، تنشأ نفوسهم على الفطرة، وهم في دور التلمذة – مرحلة الشباب: عمر ما بين 15
وعليهم الانقياد لأساتذتهم.
.2 46 سنة، وتفتح لهم أبواب الحكمة الدنيوية، ويتلقون معرفة - مرحلة الرجولة: عمر ما بين 36
بالأشياء بطريق الرمز.
.3 56 سنة، وهم يعرفون الناموس الإلهي معرفة كاملة مطابقة لدرجتهم. – مرحلة أفراد بين 46
.4 أفراد تتجاوز أعمارهم الخمسين عاما وهم أرقى الطبقات ويشهدون حقائق الأشياء.
II . المراحل العمرية عند ابن الطفيل في مصنفه حي بن يقظان.
يستند التقسيم على قصة ابن الطفيل التي يمثّل فيها الحيوان )الظبية( شخصية رئيسية ولكن بصفات
إنسانية إذ تلعب دور الأم في رعاية )حي( في جزيرة خالية من البشر مدة 56 سنة.
.1 المرحلة الأولى: من 6 إلى 7. مرحلة الرضاعة والمشي ومحاكاة أصوات الحيوانات.
.2 المرحلة الثانية: من 7 إلى 14 . مرحلة المعرفة بالملاحظة والتجربة والتفكّر للتكيّف والعيش.
.3 المرحلة الثالثة: من 14 إلى 21 . مرحلة التعرّف على وجود الروح وقضايا التجريد عبر التحليل.
.4 المرحلة الرابعة: من 21 إلى 28 . مرحلة نمو الإدراك ومعرفة خصائص الجماد والنبات والحيوان.
.5 المرحلة الخامسة: من 28 إلى 35 . مرحلة اكتشاف الخالق وعظمته.
.6 المرحلة السادسة: من 35 إلى 42 . مرحلة التعرّف على علوم الشريعة من خلال التجربة
الفلسفية والصوفية.
.7 المرحلة السابعة: من 42 إلى 56 . مرحلة التعرف على صفات العالم الإلهي والأخروي.
المراحل العمرية عند ابن سينا. .III
.1 سن النموّ: من الولادة إلى سن الثلاثين.
أ سن الطفولة: من 6 إلى 2: وهو أن يكون المولود غير مستعد الأعضاء للنهوض. -
ب سن الصبا: من 2 إلى 7: وهو بعد النهوض وقبل الشدّة. -
ت سن الترعرع: من 7 إلى 12 : وهو بعد الشدة ونبات الأسنان وقبل المراهقة. -
ث سن الغلامية: من 12 إلى 16 : إلى أن يقبل وجهه وتنمو لحيته. -
ج سن الفتى: من 16 إلى 36 : أي سنين النمو. -
.2 . سن الشباب: ما بين 36 و 46
.3 سن الانحطاط مع بقاء القوة: يمتدّ إلى عمر الستين.
.4 سن الشيخوخة مع ظهور الضعف في القوة: وهو ما بعد الستين إلى الوفاة.
بعض النقاط حول آراء ابن سينا في التربية في سني النمو:
.1 ضرورة إرضاع الأم لطفلها ما أمكنها مع تأكيده على تحليها بالأخلاق، على أن تكون الرضعة
الأولى من غير أمّه لاعتقاده بأن المرأة يختل مزاجها حين الوضع فيؤثر ذلك في الرضيع.
.2 تجنيب الصبي في سن الصبا الانفعالات الحادة كالغضب أو الخوف وتفريغه للعب.
.3 تعليمه القرآن الكريم والقراءة والكتابة في المرحلة الأولى من التعليم على أن يكون التعليم جماعيا.
.4 في المرحلة الثانية من التعليم يتم تعليمه عملا يتكسّب منه ويفيد به غيره، وهو يفضّل الصناعة
على التجارة، ويحذّر من إجبار الصبي على تعلّم مهنة لا تميل نفسه إليها.
.5 بعد التحلي بالأخلاق والعلم والأدب وإحكامه الصناعة، يسعى الوالد في تزويجه.
.6 ضرورة انتباه الإنسان لنفسه وأن لا يأمن المرء الانحراف، وهو ما أتهاه بالتربية الذاتية.
.7 تدبير العقل من خلال تعاضد القوى الظاهرة والباطنة، وتدريب كل قوة على أداء أعمالها كي
يكون أكثر استعدادا لاستقبال فيض العقل الفعّال، وتحصيل المعارف الكلية.
أنواع التدبيرات العامة لمجمل المراحل العمرية
أولا: التدبير الخلقي، وهو محكوم بمعرفة الفساد والإحاطة بجوانبه حتى لا يهمل إصلاحه.
ثانيا: التدبير الروحي، وهو ما يتعلّق بالمعرفة والسعادة الروحية.
ثالثا: التدبير البدني، أوله الرياضة وثانيه الغذاء وثالثه النوم.
IV . المراحل التربوية عند الشيخ النّراقي
أولا: التأكيد على خصوصية عمر التمييز
يقول الشيخ: إذا بلغ سن التمييز، يؤمر بالطهارة والصلاة، وبالصوم في بعض الأيام من شهر رمضان،
ويعلّم أصول العقائد وكل ما يحتاج إليه من حدود الشرع. ويؤكّد الشيخ على ضرورة تعاون الوالدان على
التربية المتاوزنة، وليكن الأب حافظا هيبته في الكلام معه، وينبغي للأم أن تخوفه بالأب.
ثانيا: ضرورة الانتباه إلى الفوارق الجنسية
إن التمييز ما بين الصبية والصبي يعدُّ إلفاتا دقيقا وهامّا وتأسيسيا لما يميّز بين الجنسين، والخصوصيّات
التربوية المتعلّقة بكل منهم.
ثالثا: أهمية الذكاءات المتعددة
يشير الشيخ إلى أنه ينبغي أن يتفرّس من حال الصبي أنّه مستعدٌ لأي علم وصناعة، فيجعل مشغولا باكتسابه ويمنع من اكتساب غيره لئلا يضيّع عمره.
المراحل العمرية في فلسفة الملا صدرا .V
.1 مرحلة النفس النباتية: من النطفة إلى تكون الجنين.
.2 مرحلة النفس الحيوانية: مرحلة الجنينية إلى الولادة، وبالتدريج إلى عمر 16 عاما، حيث تتداخل
النفس الحيوانية مع الإنسانية فيسمى حيوانا بالفعل وإنسانا بالقوّة.
.3 مرحلة النفس الإنسانية: من عمر 16 إلى 46 سنة، يسمى إنسانا بالفعل ملكوتيا بالقوة.
.4 مرحلة النفس الملكوتية: من عمر 46 إلى ما فوق، يصل فيها إلى مرتبة العقل بالفعل.
تتميّز نظرية الملا صدرا لتنمية النفس بخصائص وميّزات أهمها:
.1 أن المرحلة الأولى من التطور هي قبل الولادة، والتنمية البشرية لا تنتهي بالموت.
.2 أن جوهر الإنسان هو الإدراك.
.3 اكتمال الروح يتحقق بالمعرفة والإدراك.
.4 كل مرحلة من مراحل تكوين الأنا لها إطارها الخاص.
.5 التعليم والتدريب يتم بشكل تدريجي وخطوة خطوة.
.6 لا يمكن تدريس المفاهيم الفلسفية للأطفال قبل دخولهم مرحلة العقل.
.7 أن التربية البدنية لا تقل أهمية عن التربية الفكرية.
.8 يجب أن يكون التعليم شاملا للحس والخيال والعقل.
.9 التعليم والأخلاق مفيدان معا، فمجرّد تعلّم العلوم لن يقود الإنسان إلى الهدف.
VI . المراحل العمرية عند العلامة الطباطبائي
.1 المرحلة الأولى: الهبوط الأول وما يسمى بالطفولة الأولى، ما قبل الولادة إلى 7 سنين، وهي
مرحلة ظهور الإدراكات عند الطفل.
.2 المرحلة الثانية: الهبوط الثاني وما يسمى بالطفولة الثانية، من 7 سنين إلى سن البلوغ، تظهر
في نهايتها الحاجة إلى الشريعة، وقبول الولاية الإلهية والخلافة هي الهدف الأصيل للتربية
الدينية.
.3 المرحلة الثالثة: مرحلة البلوغ، من سن البلوغ وما فوق، وهي مرحلة صناعة ولي الله وخليفته.
VII . المراحل التربوية عند العلامة الشيخ مصباح اليزدي
قدّم الشيخ مصباح أربعة معايير تسهم في تحديد أكثر دقة للمراحل العمرية للتعليم والتربية وهي:
.1 معيار النمو والترتيب الطبيعي للقابليات .
أ. مرحلة التمهيد ما قبل الولادة، حيث تكون القابليات والاستعدادات الخاصة موضوع - التعليم والتربية. وتبدأ هذه المرحلة منذ زمان اختيار الزوجة وزواج الشخصين وتستمر حتى ولادة طفلهما.
ب مرحلة السيادة من سن الولادة إلى سبع سنين، يستفيد فيها من أدوات المعرفة ورعاية الوالدين في التجهز لمرحلة التعليم والتربية.
ت مرحلة الطاعة من سن سبع سنين إلى البلوغ 14 سنة، يصبح فيها مستعدا من الناحية الذهنية لتقبل وحفظ مختلف المطالب ويميل نحو الحياة الاجتماعية.
ث مرحلة الوزارة من سن 14 إلى 21 ، تتكامل وتتوسع خصائص الاختيار الواعي التي توفر الإمكانية للإنسان لتحصيل القيم الأخلاقية الحقيقية.
ج مرحلة الحماية ما فوق 21 ، تكون كافة القوى الرؤيوية والميولية والسلوكية قد وصلت تقريبا إلى كمال نموها.
.2 الترتيب المنطقي وكون بعض المراحل مقدّمة للبعض الآخر.
إن للإنسان ثلاثة مجالات تتمحور حول الرؤية والميل والقدرة، وأن للتربية والتعليم ثلاثة مجالات توازي
المجالات المتقدّمة، وهي عبارة عن المجالات الرؤيوية والميولية والسلوكية. إذ يمكن القول إن التربية والتعليم
في المجالين الرؤيوي والميولي، حاجة قبلية للتعليم والتربية في المجال السلوكي الاختياري. فإذا رغب المربّي
بتقوية سلوك اختياري عند المتربي، عليه بداية أن يقدّم رؤية صحيحة تتناسب مع ذاك السلوك، ثم يعمل
على تحريك الميل عنده نحو ذاك السلوك ويقدّم له المساعدة للتأثير في إرادته ليتمكن من فعله.
.3 الأولويات المبنائية، بناءً على ترتيب الهيكل التنفيذي للتعليم والتربية.
منها: تحديد أهداف التربية والتعليم، تحديد موقع المتعلّم والمتربي، تحديد الطرق الممكنة للوصول إلى
الأهداف، تحديد الإمكانات والموانع، التخطيط، تنفيذ البرامج والتقييم.
.4 الأولويات المضمونية، فإن تحقق كافة المراحل المحددة غير ممكن في وقت واحد.
بما أن الهدف النهائي للتعليم والتربية في الإسلام عبارة عن القرب من الله تعالى والذي يحصل من خلال
السير الاختياري نحو الله تعالى، يمكن القول إن الأولوية الأولى للتعليم والتربية في الإسلام هي تعليم
العلوم والمعارف وتنمية الاستعدادات والقابليات التي تؤثر في الوصول إلى القرب الإلهي.
VIII . المراحل التربوية عند خسرو باقري
.1 مرحلة التمهيد، وتقسم إلى قسمين، الأول مرحلة النشاط في السنوات السبع الأولى، والثاني مرحلة حصول قابلية التربية والتعليم في السن وات السبع الثانية )أي من السابعة لغاية البلوغ(.
.2 مرحلة الإسلام، أي البلوغ وذروة البلوغ في العقد الثاني من العمر.
.3 مرحلة الإيمان، أي الاعتدال في العقد الثالث من العمر.
.4 مرحلة التقوى، أي الاعتلاء في العقد الرابع من العمر.
.5 مرحلة اليقين، وتقسم إلى قسمين، الكهولة في العقد ل 5 و 6 و 7، والشيخوخة في 8 وما بعد.
الفصل الرابع: تقسيم المراحل العمرية وفق علماء نفس النمو والنظريات التربوية المعاصرة
i . المراحل العمرية عند جان جاك روسو
.1 ما بين سنة و 5 سنوات، مرحلة التربية السلبية التي تمنح الطفل حريته الكاملة.
.2 ما بين 5 و 12 سنة، تكون التربية فيها موجهة نحو تقوية الجسم وتمرين الحواس.
.3 ما بين 12 و 15 سنة، مرحلة القراءة واكتساب الثقافة.
.4 ما بين 15 و 26 سنة، المرحلة الأنسب لتعليم الدين، والتربية الجنسية.
.5 26 وما فوق، مرحلة تعليم الزوجين الحقوق والواجبات، فهذا عمر الجنس والزواج.
أبرز الانتقادات: تجاهل التعليم الأكاديمي، نظرية الطفولة السعيدة، قلة التفاصيل العملية ...
ii . نظريات النمو المعرفي )برونر، بياجيه(
نظرية بياجيه في التطور والنمو المعرفي
.1 المرحلة الحسية الحركية من الولادة إلى السنتين. وخصائصها: التعرف على العالم عبر حواسه، يدرك أنه كائن منفصل.
.2 مرحلة ما قبل العمليات من 2 إلى 7 سنوات. يعرض الطفل في هذه المرحلة السلوكيات التالية: التقليد، الترميز، الرسم، التصوير الذهني والتوصيف اللفظي. خصائصها: التفكير بشكل رمزي، التمركز حول الذات، التحسن في اللغة والتفكير.
.3 مرحلة العمليات الملموسة من 7 إلى 11 سنة. يشهد الطفل في هذه المرحلة تطورا من خلال: استقراء الأحداث، تدني الشعور بالأنانية.
.4 مرحلة العمليات المجرّدة من 11 سنة وما فوق. تتطور خلال هذه المرحلة القدرة على الاستنباط.
نظرية جيروم برونر
.1 المرحلة الحكمية، التوضيح النشط. اكتساب المعرفة من الأنشطة الحركية.
.2 المرحلة التصويرية التقليدية، التوضيح بالصور. القدرة على فهم المعلومات دون أن تتم في صورة
أفعال.
.3 المرحلة الرمزية. استخدام الكلمات بدلا من الصور.
أبرز الانتقادات: الانحياز الثقافي، انتقائية في الأبحاث، التأثير على التعليم.
iii . نظريات التفكير الأخلاقي
.1 نظرية بك وهافجهرست تعتمد على وجود 5 أنماط من الخلق وهي: الحياد الأخلاقي في الطفولة، الوسيلية في الطفولة المبكرة، المسايرة في الطفولة المتأخرة، الضمير اللاعقلاني في الطفولة المتأخرة والغيرية العقلانية في المراهقة.
.2 نظرية كولبرج تقسم إلى 3 مستويات. المستوى الأول هو قبل التقليدي من الطفولة إلى سن التاسعة. المستوى الثاني هو التقليدي وفيه مرحلتان، الأولى الولد الطّيب والثانية التوجّه نحو المحافظة على النظام. المستوى الثالث هو ما بعد التقليدي وفيه مرحلتان أيضا، الأولى مرحلة التعاقد الاجتماعي والثانية التمسك بمبدأ أخلاقي عام.
أبرز الانتقادات: إغفال العوامل الثقافية والاجتماعية، عدم إمكانية تعميم النموذج، غياب التفسيرات الفلسفية للنظام الأخلاقي، عدم وضوح مدى تأقلم هذه النظريات مع التطورات الأخلاقية.
iv . النمو النفسي الجنسي )فرويد(
.1 المرحلة الفمية (1-6) تتميّز بتمركز الإحساس بالإشباع الجنسي في الفم بالرضاعة أو التقبيل، وتكون سلبية في الأشهر الستة الأولى )امتصاص(، وسادية في الأشهر الستة الثانية )عض(.
.2 المرحلة الشرجية (1-3)، إخراج الفضلات يشكل لذة تخلصه من توتره الشرجي.
.3 المرحلة القضيبية(3-6)، تتميز بنمو جنسي إدراكي للأعضاء الجنسية. وفي هذه المرحلة تصبح الأعضاء التناسلية المولد الرئيسي للشهوة، ما يهيئ لظهور عقدتي أوديب وهي الرغبة في امتلاك الصبي لأمه والبنت لأبيها والخصاء وحسد القضيب خوف الابن من أن يخصيه.
والده لأنه يرى نفسه منافسا له، وحسد الفتاة للرجال لامتلاكهم شيئا لا تملكه.
.4 المرحلة الكامنة ) 6 سن البلوغ(، وهي مرحلة خمود الطاقة الجنسية. -
.5 المرحلة التناسلية )بعد البلوغ(، تعتبر فترة النشاط الجمعي والزواج وإنشاء الأسرة ورعايتها.
أبرز الانتقادات: التركيز في التحليل على الذكور أكثر من الإناث، عدم قابلية التجربة، غموض التصورات المستقبلية، اعتماد منهج دراسة الحالة وليس المنهج التجريبي، اعتقاده المرأة أقل درجة من الرجل، تأثر آراء فرويد بالحالات المرضية.
v . نظريات النمو النفسي الاجتماعي )إريكسون ومارشيا نموذجا(
.1 نظرية النمو النفسي الاجتماعي لإريك ه. إريكسون. تقسم إلى ثمان مراحل:
- من صفر إلى 12 شهر وهي مرحلة اكتساب حاسة الثقة مقابل الشك.
- من 12 شهر إلى ثلاث سنوات وهي مرحلة تطور حاسة الاستقلال الذاتي مقابل الخجل.
- من 4 إلى 5 سنوات وهي مرحلة اكتساب حاسة المبادرة مقابل الإحساس بالذنب.
- من 6إلى 11 سنة وهي مرحلة اكتساب حاسة الاجتهاد مقابل الإحساس بالنقص.
- من 11 إلى 26 سنة وهي مرحلة اكتساب الإحساس بالهوية مقابل الضياع.
- بعد عمر العشرين وهي مرحلة اكتساب حاسة التكامل مقابل الإحساس بالعزلة.
- من عمر الشباب إلى بداية الشيخوخة وهي مرحلة اكتساب الإحساس بالإنتاج مقابل الركود.
- مرحلة الشيخوخة وهي مرحلة اكتساب حاسة التكامل مقابل اليأس.
.2 نظرية تشكيل الهوية لجيمس مارشيا. وتتركز أشكال الهوية الأربعة فيما يلي:
- تحقق الهوية والتي تعبر عن تكامل ونمو الشخصية.
- توقّف الهوية أو التأجيل المسبق وهي مرحلة سابقة على تحقق الهوية.
- إعاقة تكوين الهوية أو الانغلاق لعدم قدرته على الاستكشاف.
- تشتت الهوية وهي أقل مستويات نمو الشخصية.
أبرز الانتقادات: قسمة المراحل بشكل صارم، عدم وجود دلائل علمية، تجاهل للعوامل البيولوجية،
تبسيط العمليات النفسية، الانتقادات الثقافية.
vi . المراحل العمرية عند مونتيسوري
.1 من الولادة حتى 6 سنوات، وتقسم إلى ثلاثة مراحل، مرحلة العقل المستوعب، الفترات
الحساسة، فترة الوعي الكامل.
.2 من 6 حتى 12 سنة، الميل إلى العمل في مجموعات، تطور الخيال والحس الأخلاقي، تشكيل
الاستقلال الفكري، تطور حب التعلم والمعرفة.
.3 من 12 حتى 18 سنة، فترة المراهقة.
.4 من 18 حتى 24 سنة، مرحلة النضوج.
أبرز الانتقادات: نقص التوجيه، عدم تحقيق التحفيز المعتدل، عدم مرونة النظرية، عدم معالجة التنوع
الثقافي، تجاهل تطوير القدرات الاجتماعية.
vii . نظرية فيجوتسكي في النمو المعرفي ومراحل تطور المفاهيم
.1 مرحلة التفكير التجميعي من الشهر الأول حتى الثامن، يمتلك الطفل في هذه المرحلة قدرة على
التذكر واستكشاف هوية الأشياء والربط بين التصرفات.
.2 مرحلة التفكير التعقيدي من الشهر الثامن حتى 12 شهرا، يقوم فيها الطفل بتصنيف الأشياء
بشكل موضوعي أكثر.
.3 مرحلة تكوين المجاميع من سنة حتى سنتين، حيث يقوم بإنشاء عدد من الجم وعات المتكاملة.
.4 مرحلة العقد المتسلسلة من سنتين إلى 4 سنوات، يقوم بتصنيف الأشياء على أساس صفات
معينة، ويبدأ بربط صفة أخرى بهذا الشيء.
.5 مرحلة العقد المصقولة من 5 إلى 6 سنين، تزداد لدى الطفل المرونة والإدراك.
.6 مرحلة أشباه المفاهيم من 6 إلى 8 سنوات، يبدأ الطفل بتجميع المفاهيم بدون قاعدة.
.7 مرحلة تكوين المفاهيم فوق 8 سنوات، وهي تطور طبيعي لإدراك الأشياء.
أبرز الانتقادات: عدم القدرة على تفسير التنمية الذاتية، تجاهل البعد الاجتماعي والثقافي، قيود في تطبيق
النظرية، قلة التوجيه.
خاتمة: مقارنة وتقييم بين النظريات التربوية في تقسيم المراحل العمرية والنموذج المختار في تقسيمها
أولا: نظريات المفكرين التربويين الإسلاميين
.1 تقسيم المراحل العمرية عند المفكرين المسلمين أتى عرضا في سياق بحث المفكر عن هوية النفس.
.2 يظهر حضور النص الشريف في مساعدة المفكر الإسلامي على صياغة رؤية متقاربة ومتناسقة ما
بين المفكرين الإسلاميين خصوصا في التقسيم الثلاثي المشهور بين المسلمين.
.3 يظهر اتجاه شبه تجريبي في محاولات المفكرين المسلمين الأوائل في تحديد خصائص المراحل العمرية
.4 ظهرت في كتابات المفكرين الأوائل بذور أولية لإعطاء الفوارق الجنسية مساحة خاصة.
.5 ابتداع تصنيف تربوي غير مسبوق يعتمد على الأحكام الشرعية الإسلامية.
.6 الاعتماد على النص الديني في تقسيم المراحل العمرية بإجماع أغلب المفكرين.
ثانيا: التصور المتحصل في تقسيم المراحل العمرية
|
التصور المقترح للمراحل العمريّة |
|||||
|
المرحلة العمريّة |
التحديد الزماني |
الخصائص الجسدية |
الخصائص الادراكية |
الخصائص العاطفية والسلوكية |
|
|
1- المرحلة الإعدادية الإلهية العامة |
ما قبل الولادة |
الاعداد للنمو الجسدي في مرحلة تكون النطفة والبويضة والحمل والولادة |
مدخلية الحالة المعرفية للوالدين |
الحالة المعنوية للوالدين والسلوكية (الطهارة، اجتناب الحرام.) |
|
|
2- الطفولة (0-7) |
الطفولة الأولى |
(0-3) |
اللعب/الرعاية الصحية والبدنية والخبرات الحسية |
مرحلة تجريدية أولية ما قبل رمزية |
|
|
الطفولة الوسطى |
(3-5) |
اللعب |
الادراك الرمزي/تطور التجريد والخيال |
التعرف على معاني عبادية |
|
|
5-7 |
اللعب /الاعداد لمغادرة مرحلة اللعب والتهيؤ لمرحلة الالزام |
التَّمييز العقلاني/ التعلم العقلاني |
ممارسات عبادية أولى كالسجود |
||
|
3-سن التَّمييز |
عند الفتيان |
(7-12) |
|
مرحلة التعلم والتأديب الالزام في التربية استعمال أنواع من العقوبة حتى البدنية اهلية قبول الاسلام والمعاملات المالية |
ازدياد القدرة على التحكم بالمشاعر والتعبير عنها اتساع مجالات واتصلات الطفل بالعالم الخارجي |
|
عند الفتيات |
(6-9) |
|
مرحلة التعلم والتأديب الالزام في التّربية استعمال أنواع من العقوبة حتى البدنية اهلية قبول الاسلام والمعاملات المالية اختلاف انماط التَّمييز استيعاب المفاهيم وأشباه المفاهيم اهتمام متزايد بقضايا الزواج والأمومة |
ازدياد القدرة على التحكم بالمشاعر والتعبير عنها اتساع مجالات واتصلات الطفل بالعالم الخارجي
|
|
|
4-المرحلة الأولى من البلوغ الشرعي (مرحلة الإعداد) |
الذكور |
من سن 12-15 |
-بروز العلامات الجسدية الدالة على البلوغ. -تنامٍ في البنية الجسدية والعضلية. ازدياد ملحوظ في الرغبة الجنسية القدرة على الانجاب |
بروز مؤهلات فكرية ومعرفية تجريدية ذات مستووى عالٍ لتقبل مفاهيم معقدة. حضور التكليفي الشرعي والدِّيني كمحور بارز في تشكل الشخصية بروز الاستقلالية المعرفة والفكرية عن الأهل التأثر بالبيئة المحيطة فكريا ومعرفيا |
القلق والفضول حول الجنس هو عنوان المرحلة اضطرابات مرحلة المراهقة تشنجات في السلوك الاجتماعي تشكل الشخصية العاطفية والنفسية |
|
الاناث |
من سن9- 15 |
-بروز العلامات الجسدية الدالة على البلوغ. -تنامٍ في البنية الجسدية والعضلية. ازدياد ملحوظ في الرغبة الجنسية القدرة على الانجاب |
بروز مؤهلات فكرية ومعرفية تجريدية ذات مستووى عالٍ لتقبل مفاهيم معقدة. حضور التكليفي الشرعي والدِّيني كمحور بارز في تشكل الشخصية بروز الاستقلالية المعرفة والفكرية عن الأهل التأثر بالبيئة المحيطة فكريا ومعرفيا |
القلق والفضول حول الجنس هو عنوان المرحلة اضطرابات في السلوك نتيجة الطمث المبكر الانجذاب العاطفي الكبير نحو الجنس المخالف |
|
|
5-المرحلة الثانية من البلوغ الشرعي
|
الذكور |
15-21 |
مؤشرات نمائية عامة:
|
||
|
الاناث |
15-21 |
||||
|
6- مراحل البلوغ المتقدمة (21- إلى آخر العمر) |
21-28 |
مؤشرات نمائية عامة ترتبط بالعلاقة الجدلية بين النّموّ الجسدي والمعرفي والعاطفي وتحمل المسؤوليات الدِّينية والإنسانينة، وتعقّد شبكات العلاقة والروابط بين الإنسان والكون والله والآخر. |
|||
|
40-65 |
|||||
|
65-80 80-90 |
|||||
|
7-الحياة بعد الحياة |
عالم الآخرة |
وهي المرحلة النمائية الأعلى والأكمل في حياة الإنسان والتي تشكل كلّ المراحل العمريّة الفائتة مقدمةً من أجل بنائها. فهي إذن المرحلة الأهم في حياة الإنسان وتمتد إلى ما لا نهاية بحسب الاعتقاد الإسلامي في كونها هي "الحياة" الحقيقية. وتتسم باكتمال المعارف، واكتمال البنية الجسمانية الملائمة للخلد، وتحضر فيها كافة الأبعاد الإنسانينة تحت رعاية مباشرة من الغيب الإلهي. |
|||
والحمد لله رب العالمين
21 ذو القعدة 1445 هـ
تعليقات