دراسات ومقالات المركز
التربية والتعليم في ظل الأزمات والحروب
د. علي الرضا فارس *
تعريف الأزمة
تُعرّف الأزمة بأنها "نقطة تحوّل في أوضاع غير مستقرّة، قد تقود إلى نتائج غير مرغوبة إذا كانت الأطراف المعنية غير مستعدة أو غير قادرة على احتوائها ودرء أخطارها" (خلوق، 2020، صفحة 90).
والأزمة هي "ظرف انتقالي يتسم بعدم التوازن ويمثل نقطة تحول تحدد في ضوئها أحداث المستقبل التي تؤدي إلى تغيير كبير" (مريم، 2019، صفحة 11).
كخلاصة، الأزمة هي اختلال لتوازن موجود، وهي عبارة عن حدث مفاجىء له تبعات سلبية فردية أو جماعية. والحرب هي نوع من أنواع الأزمات، التي تكون سريعة وقاسية النتائج وتحتاج وقتًا طويلاً لترميم خسائرها على الأطراف المتقاتلة فيما بينها.
والأزمات هي بلاءٌ يصاب به كل البشر ضمن صيرورة الحياة ومسارها الطبيعي، بسم الله الرحمن الرحيم "وَلَنَبلُوَنَّكُم بِشَيءٍ مِنَ الخَوفِ وَالجُوعِ وَنَقصٍ مِنَ الأَموَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ" (القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 155).
مسار الأزمات والحروب المعاصرة في مجتمعنا
تعاني منطقتنا بشكل عام وبلدنا لبنان بشكلٍ خاص من عددٍ من الأزمات المتعددة الأبعاد، فباستعراض أبرز تسلسل للأحداث السلبية والضغوط الصدمية التي واجهها المجتمع اللبناني من العام 2019 م حتى العام 2025 م، كانت على الشكل الآتي:
- تدهور اقتصادي.
- اضطرابات سياسية.
- وباء جائحة كورونا.
- هزات أرضية قوية وهزات ارتدادية غير مألوفة.
- تهديدات عسكرية وأمنية إسرائيلية موضعية وشاملة.
- الحرب الهمجية الأميركية الإسرائيلية الأخيرة على لبنان في أيلول 2024 م.
- اغتيالات غير مألوفة، وعلى رأسها اغتيال الأمين العام السيد الشهيد الأسمى (رضوان الله عليه)، واستهداف قيادات في المقاومة.
- نزوح وعوز وشعور بالضعف أو الخطر أو الحصار.
- تحدي العودة وإعادة الإعمار.
- تحدي التغيّرات الجيوسياسية في المنطقة والتي لها أثر مباشر على لبنان (كانهيار النظام في سوريا).
هذه الأزمات جميعها أدّت لأحداث سلبية جوهرية فردية أو جماعية، وكذلك لصدمات فردية أو جماعية. وتأثير هذه الأحداث كان تحريض قلق المستقبل لدى الجماعة والأسئلة الوجودية، وتركيز انشغال البال في قضايا السلامة الفردية والجماعية، هبوط الجهد الفكري المدرسي إلى أدنى سلّم الأولويات (سلوم، 2025).
طرق واستراتيجيات التربية والتعليم في ظل الأزمات والحروب
بعد تعريف الأزمات والحروب، وعرض مسار الأزمات التي مرّ بها المجتمع اللبناني في السنوات الأخيرة.
سيتم طرح السؤال الآتي: هل تستلزم كل هذه الأزمات والحروب التغيير بطرق واستراتيجيات التربية والتعليم لدى المربين والمعلمين؟
الجواب البديهي هو نعم، ولكن ما هي النقاط التفصيلية الإجرائية لهذه الإجابة، هذا ما سيتم توضيحه في هذه المقالة.
1- في التربية:
القاعدة الأساسية في التربية في ظل الأزمات هي البناء على عاملي الصبر والمرونة، فهذان العاملان هما كلمة السرّ في المحافظة على النسق التربوي المتَّبَع من قِبَل المربيّن، فالصبر من قبل المربي على المتربي هو الأساس الأوّل في مواكبة هذه التحولات العنيفة من أزمات وحروب، والمرونة التي يعطيها المربّي في الجرعات التربوية التي يتلقاها المتربي هي الأساس الثاني لبقاء فكرة القبول من قبل المتربّي لتنشئته على المنظومة القيمية التي يتبناها المجتمع.
وإضافةً لهذين العاملين، يجب تضافر عدة نقاط إجرائية مساندة لهذين العاملين، وهي على الشكل الآتي:
- توفير بيئة آمنة وداعمة: من خلال خلق جو من الطمأنينة والاستقرار داخل المنزل أو خارجه حيث يمكن أن يساعد هذا الجو الأطفال على الشعور بالأمان، مما يدعّم قدرتهم على تلقّي القيم التربوية والمحافظة عليها. وهذه البيئة الآمنة يتم توفيرها بناءً على التواصل والإصغاء الفعّال وفهم المخاوف المحيطة بالأطفال.
- الحفاظ على التواصل المفتوح ما بين المربي والمتربّي: بهدف تشجيع الأطفال على التعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم والتحدث عن ما يواجهونه مما يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر لديهم.
- نشر الكلام الإيجابي للأطفال ورفع معنوياتهم دومًا: فطبيعة أعمارهم وقدراتهم العقلية والنفسية تتسم بالهشاشة، وبحاجة للطّمأنة من خلال كلام المربين الراشدين.
- استمرارية الدعم: فعملية الدعم المعنوي والنفسي للأطفال هو عملية مستمرّة، ولا يكفي مجرد الخضوع لجلسة إرشادية أو حلقة دعم معنوي لهؤلاء الأطفال، لكي تهدأ نفوسهم، فعملية المساندة والدعم العاطفي والنفسي يجب أن تتّسم بالاستمرارية وعلى مدى يتخطى انتهاء الأزمة نفسها.
- معاودة الروتين اليومي: فالعودة لروتين العمل اليومي للطفل يساهم باستقراره من خلال شعوره بالعودة لفترة ما قبل حصول الأزمة.
- إبعاد الأطفال عن مصادر القلق: من خلال حجب الأخبار بشكل عام والأخبار العنيفة بشكلٍ خاص عن مسمع الأطفال، إن على التلفاز أو عبر الهاتف.
- الصدق مع الأطفال: ضرورة التعامل بصدق مع الأطفال، وعدم تضخيم الأحداث/الأزمة أو الكذب في مضمونها لتخفيفها، بل يجب الحديث مع الأطفال بالحقائق كما هي، مع مراعاة قدراتهم العقلية والنفسية حول الجرعات التي باستطاعتهم استيعابها وبالطريقة الأبسط (مثلاً: نكون واقعيين معهم بأن العدو الإسرائيلي هو عدو متغطرس وقاتل وغير أخلاقي ويمتلك أدوات تكنولوجية عسكرية أعلى مما نمتلك نحن، وبالتالي فليس من الغريب أن يقوم بقصفنا، ولكننا في المقابل لدينا شبابًا مجاهدين يمتلكون إرادةً وإيمانًا وثقةً بالله تعالى أكثر مما يمتلك هذا العدو وجنوده، ومجرد وقوفنا في طريق الحق هو انتصار لنا على الظلم).
2- في التعليم:
"التعليم بأبعاده المختلفة عمليّة بنائيّة وتفاعليّة ترتكز إلى إطار اجتماعيّ- ثقافيّ محدّد، فكيف نعلّم إذًا في سياق الحرب أو الأزمات؟ فمن المعروف أنّ التغيّرات التي تحدثها الحروب لها تأثيرها، في النظم التعليميّة ودور المدارس ومهمّاتها، ومهمّات المعلّم واحتياجاته واحتياجات الطلّاب واهتماماتهم وتطلّعاتهم أيضًا. وغالبًا ما يكون المعلّم في الصفوف الأماميّة لدعم العمليّة التعليميّة من دون أن يحصل بالضرورة على مؤازرة ومساندة وتطوير مهنيّ لتسهيل مهمّاته في سياق يتّسم بتحدّيات استثنائيّة، ولا سيّما لناحية دعم الطلّاب، لما قد يعانونه من فقدان وصدمات وغياب دافعيّة التعلّم" (الخليل، 2025).
فالنسق التعليمي هو نسقٌ تربوي أسوة بالأنساق الأخرى، وبالتالي فاستراتيجية الصبر والمرونة خلال الأزمات والحروب هي حاجة ضرورية في العمليات التربوية التي يقوم بها هذا النسق، والتي يتم من خلالها نقل الأفكار والقيم للتلامذة والطلاب. إضافةً إلى الرسالية في العمل، فالمعلّم ومن يعمل في مجال التعليم من إداريين وغيرهم هم رُسٌلٌ لتلامذتهم، وليس مجرّد وظيفة يقومون بإنجازها، فهم يبنون الإنسان وليس أي شيء آخر.
ولهذا النسق التعليمي خصوصيته عن باقي الأنساق، حيث يُعدّ الشكل الأكثر نظاميةً ومنهجيةً في التربية على القيم، من خلال منهاج علمي محدّد المعالم والأهداف الواضحة منها والخفيّة. ولهذا فالتعليم خلال فترة الأزمات والحروب يختلف عنه في الفترات التي تكون خارج هذه الأحداث الصدميّة.
أما طريقة التعامل من التلامذة والتعليم بشكلٍ إجرائي خلال الأزمات فتكون على الشكل الآتي:
- تراكم التجربة: بدايةً إذا ما قاربنا الحرب الإسرائيلي على لبنان في الـ2024 م، فإن القطاع التعليمي اللبناني قد استفاد من التجربة التراكمية التي مزجت ما بين حرب 2006 م ووباء كورونا 2019 م، وبالتالي زادت قدرته في كيفية إدارة العملية التعليمية خلال الأزمات، انطلاقًا من فكرة تراكم التجربة.
- التعلم من بُعد والتعلم الإلكتروني: في ظل الأزمات مثل جائحة كوفيد-19، وخلال الحرب الإسرائيلية على لبنان 2024 م، أصبح التعلم الإلكتروني والتعلم من بُعد أدوات رئيسية لضمان استمرارية التعليم، حيث يمكن أن تشكل الأزمات والحروب الحافز لتسريع تبني التكنولوجيا في التعليم. وبالتالي فضرورة استكمال التعليم وعدم انقطاعه، هو أساس لمحاولة الحفاظ على الروتين التعليمي اليومي للتلامذة، ولتخفيف نسب الفاقد التعليمي.
- ترشيق المناهج: خلال الأزمات والحروب يجب ترشيق وتطويع المناهج لتتكيف مع الظروف المتغيرة، بحيث من غير الواقعي اعتماد نفس المناهج (كبيرة الحجم) ما بين الوضعي الطبيعي والوضع الذي يتّسم بالأزمات، لأن قدرات التلامذة ليست بأعلى مستوياتها، وبالتالي فالهدف لا يكون التحصيل بمستوياته العليا بقدَر ما يكون الهدف هو مجرد عدم الانقطاع عن التعلّم ولو بمستوياته الدنيا.
- التقييم: خلال فترات الأزمات والحروب على المؤسسة التعليمية اعتماد نوع من التقييم البسيط والمخفّف المرتكز على المهارات التي يحصلها التلامذة وعلى قدراتهم في الصمود، وليس فقط المعارف التلقينية الحفظية (فمثلاً ليس من الخطأ أن يشتمل التقييم على علامات ودرجات تدعم التلميذ بمجرد مواكبة هذا التلميذ للعملية التعليمية من بعد).
- الدعم النفسي: الأزمات قد تؤثر على الصحة النفسية للطلاب (فيعاني البعض من الفاقد النفسي)، مما يستدعي توفير دعم نفسي للتلاميذ والأهالي والمعلمين. مع ضرورة التركيز أن تكون عملية الدعم والتفريغ النفسي هي عملية مستمرة لمدة عام دراسي تقريبًا لما بعد مرحلة الأزمة، خاصةً لمن يعانون من الفقد البشري (أحد الأهل استشهد خلال الحرب، أو جرح،..إلخ)، أو الفقد المادي (تهدم منزل العائلة، النزوح،..إلخ).
- الدعم المادي: في الأزمات والحروب، على المؤسسة التعليمية أن تقوم بأدوار اجتماعية مادية لدعم الطلاب المتضررين (مثلاً: حسم إضافي للنازحين، تأمين كتب لمن تهدمت بيوتهم،..إلخ). وكذلك الأمر بالنسبة للمعلمين المتضررين على وجه الخصوص من خلال تأمين المقومات المادية الإضافية التي تساعدهم على الصمود والعطاء.
- الدعم التعليمي: ضرورة توفير برامج دعم أكاديمي فردية لردم الفاقد التعليمي خاصة للطلاب المتأثرين بالأزمات والحروب، حيث يمكن أن يساعدهم هذا الدعم في تحسين تحصيلهم الدراسي.
- تعزيز المواد الإجرائية والأنشطة الترفيهية الصفية واللاصفية: تساهم المواد الإجرائية (الرسم، الرياضة،..إلخ) والأنشطة الترفيهية الصفية واللاصفية في عملية التفريغ النفسي وزرع الجو الإيجابي لدى التلامذة، ولهذا تزداد أهميتها في فترة ما بعد الأزمات والحروب بهدف المساعدة في عملية المعافاة الجماعية لكامل المجتمع المدرسي.
- تعزيز الشراكة مع الأهل: خلال الأزمات والحروب وبعدها، هناك ضرورة لدى المؤسسات التعليمية لزيادة جرعات التواصل وتعزيز الشراكة مع الأهل، حيث يفيد هذا التواصل بعدّة أمور منها: شعور الأهل بارتباطهم مع المؤسسة التربوية التعليمية من خلال تواصل المؤسسة معهم وسؤالهم عن أحوالهم. تعزيز التعلّم بالنسبة للتلامذة من خلال شعور الأهل بالمسؤولية التعليمية المطلوبة منهم خلال فترة الأزمة. شعور الأهل والتلامذة بالاطمئنان بأن المؤسسة التعليمية هي ليست فقط مؤسسة للتعليم خلال فترات الرخاء بل هي مرجعية ودعم وسند تربوي لهم خلال فترات الأزمات والحروب.
- استمرارية التواصل: لا يكفي مجرد وجود التواصل خلال وبعد الأزمات والحروب مع الأهل والتلامذة، بل على هذه العملية أن تتصف بالاستمرارية والديمومة بشكل مفتوح على الأقل لعام دراسي واحد لرصد كل التغيّرات، حيث أن بعض المشكلات وخاصة النفسية منها قد تحتاج لوقت طويل لكي تظهر، ولا تظهر خلال يوم أو يومين فقط.
- التركيز على التعليم العملي: خلال الأزمات والحروب، يمكن التركيز على التعلم الذي ينمي المهارات الحياتية والعملية (مثلاً: الطبخ، صيانة كهربائية،..إلخ)، أو التعلم المرتكز على التدريب المهني والذي يساهم في إعادة بناء المجتمعات المحلية المتضررة.
في الخلاصة، التربية والتعليم في ظلّ الأحوال العادية الطبيعية المستقرّة، هي عمليات تحتاج جهدًا ووقتًا وعزيمةً من قبل المربين والمتربين على حدٍّ سواء، فكيف بالأحوال الاستثنائية غير الطبيعية وغير المستقرّة كالأزمات والحروب وغيرها...إلخ، حيث تصبح هذه العمليات بحاجةٍ لجهودٍ مضاعفة، ولاستراتيجيات وتقنيات مختلفة عمّا هو معتمد في الأحوال الطبيعية الروتينية، بهدف الحفاظ على هذين المسارين (التعليمي والتربوي)، الذين يبنيا الإنسان السويّ السليم ويحفظا المجتمع بقيمه الحاكمة.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- أوليدي مريم. (2019). إستراتيجية إدارة الأزمات في المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية. ورقلة: جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية.
- توفيق سلوم. (2025). الأحداث الصدمية وتأثيرها على الدافعية للتعلم والتوجه المهني. التوجيه المهني ما بعد الحرب. بيروت: المركز الإسلامي للتوجيه والتعليم وبرعاية جامعة المعارف.
- سوزان الخليل. (6 كانون الثاني, 2025). تغيير طرق التعليم في ظل الحروب.
- هشام خلوق. (2020). مفهوم الأزمات الدولية وآثارها. مجلة الرائد في الدراسات السياسية، 2(3)، 88-102.
د. علي الرضا فارس : مرشد الدراسات الأكاديمية في مركز الأبحاث والدراسات التربوية
آخر تحديث : 2025-04-22
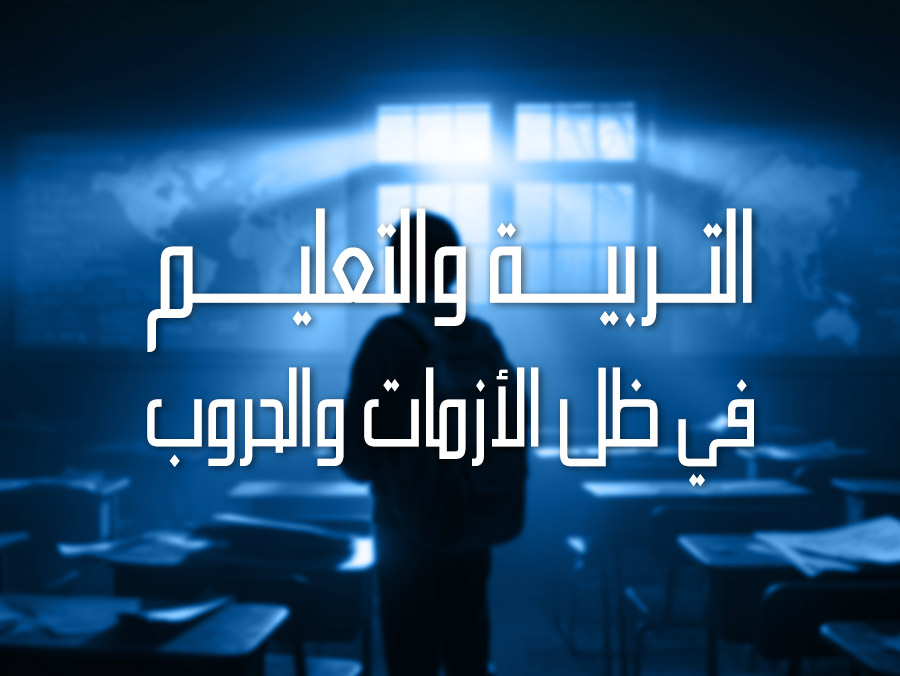


تعليقات