الطلاب والذكاء الاصطناعي: أي مصير لمهارات التفكير في عصر الخوارزميات؟
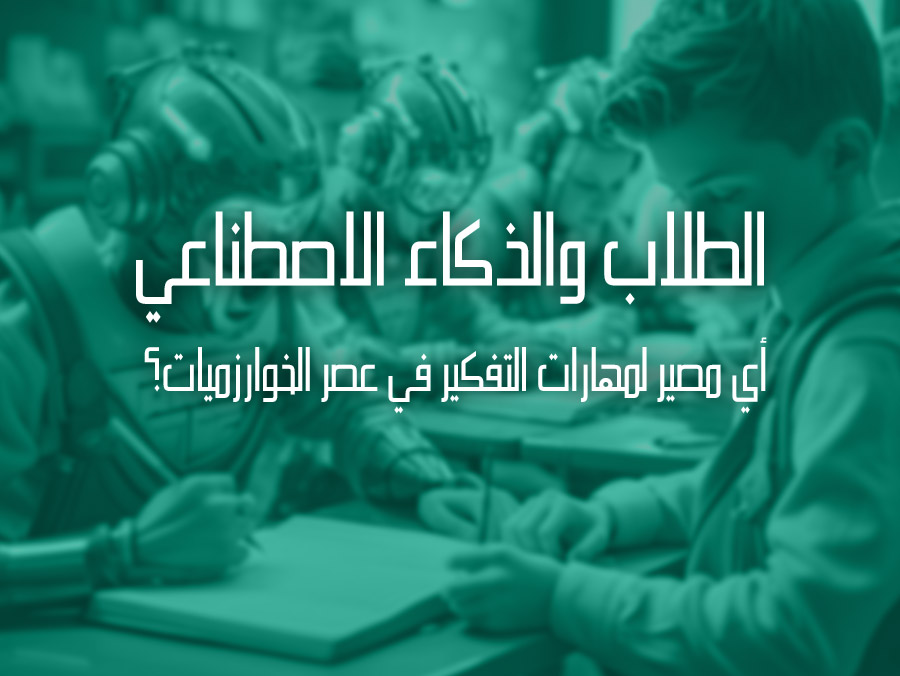


أ.سامر جابر
يشهد التعليم في العصر الراهن تحوّلًا جذريًا مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي أصبح استخدامها شائعًا في مختلف المستويات التعليمية. وبينما تُسلّط الأضواء على القدرات الهائلة لهذه التقنيات في دعم التعليم، يبرز تساؤل جوهري: هل يُعزز الذكاء الاصطناعي مهارات التفكير لدى الطلاب، أم يُضعفها؟
تهدف هذه الورقة إلى استكشاف أثر الذكاء الاصطناعي على مهارات التفكير لدى الطلاب، من خلال تحليل الأدبيات الحديثة التي تسلط الضوء على الأبعاد المعرفية والتربوية لهذه العلاقة المتنامية. وينطلق هذا التحليل من رؤية نقدية تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مزدوجة التأثير: فهو من جهة، يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات؛ ومن جهة أخرى، يثير مخاوف حقيقية بشأن الانحدار المعرفي المحتمل نتيجة الإفراط في الاعتماد عليه دون تأطير تربوي مناسب.
ولفهم هذا التوازن بين الفرص والمخاطر، تستعرض الورقة أبرز ثلاث مهارات فكرية رئيسية يتأثر بها الطلاب في ظل الذكاء الاصطناعي، وهي: التفكير النقدي، والإبداع، وحل المشكلات، بالإضافة إلى الاعتبارات الأخلاقية التي تفرض نفسها على الممارسة التربوية المعاصرة.
أولا: دعم التفكير النقدي: تمكين مشروط
تُظهر عدة دراسات أن الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرة حقيقية على دعم التفكير النقدي لدى الطلاب، من خلال توفير بيئة تفاعلية تسمح بتقييم المعلومات، وتوليد الحجج، وتفنيد الآراء من زوايا متعددة. وتكمن قوة الذكاء الاصطناعي في قدرته على طرح سيناريوهات بديلة، وتحفيز الطالب على التفكير خارج القوالب المعتادة، عبر مقارنات دقيقة بين الحجج والاستنتاجات، بل وحتى استكشاف التحيزات المنطقية ضمن النصوص أو الردود التي يُنتجها النموذج. على سبيل المثال، أوضحت دراسة Atenas et al. (2025) أن استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الأنشطة الصفية شجّع الطلاب على تحليل المخرجات وتحديد الثغرات فيها، مما عزز من وعيهم النقدي ومهاراتهم التحليلية.
وقد أظهرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، فعاليتها في إثارة تساؤلات معقدة تدفع المتعلمين إلى التفكير الجدلي والتقييمي، خاصة عند استخدامها تحت إشراف تربوي واعٍ يربطها بالأهداف التعليمية. وفي هذا السياق، تؤكد بعض الدراسات على أن الطلاب الذين يُوجَّهون لاستخدام هذه الأدوات بطريقة نقدية، يظهرون تحسنًا في مهارات طرح الأسئلة، والتفكير التأملي، والتمييز بين الآراء المبنية على أدلة وتلك المعتمدة على فرضيات سطحية.
إلا أن الجانب السلبي لا يقل أهمية، إذ يُحذر Arcinas (2024) من أن الاستخدام السطحي وغير الموجَّه للأدوات الذكية قد يحوّل الطالب إلى متلقٍ سلبي يعتمد على إجابات جاهزة، دون بذل جهد معرفي حقيقي. فبدلًا من تشغيل العمليات العقلية العليا مثل التحليل والتركيب، قد يكتفي بعض الطلاب بنسخ وتكرار إجابات النموذج، ما يعمّق ظاهرة الاتكالية الفكرية. هذا النمط من "الكسل العقلي"، كما يسميه بعض الباحثين، يؤدي إلى تآكل تدريجي في مهارات التقييم الذاتي والمنطقي، ما يُهدد بتراجع قدرة الطالب على التمييز والاستدلال المستقل، ويُضعف الحس النقدي الذي يُفترض أن يكون نتاجًا أساسيًا للعملية التعليمية.
وعليه، فإن فعالية الذكاء الاصطناعي في تعزيز التفكير النقدي تظل مرهونة بطريقة استخدامه: فبينما قد يتحول إلى محفّز معرفي إذا وُظّف بطريقة تفاعلية وتحليلية، قد يصبح عاملًا مُثبطًا إذا اقتصر دوره على توفير إجابات فورية دون مناقشة أو مساءلة.
ثانياً: الإبداع بين التحفيز والتقليد
يُعتبر الإبداع من أكثر المهارات تأثرًا بالذكاء الاصطناعي، سواء من حيث التطوير أو التراجع. فالتفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل نماذج اللغة الكبيرة، يفتح أمام الطلاب أبوابًا جديدة لاستكشاف أفكار غير تقليدية، خاصة في المجالات التي تتطلب تفكيرًا مفتوحًا وغير خطي. ووفقًا لـ Haider et al. (2024)، فإن أدوات التوليد التلقائي تُمكن المستخدمين من إنتاج أفكار غير مألوفة تتجاوز النمطية المعتادة في الكتابة أو الحلول، ما يشجع الطلاب على تطوير إجابات إبداعية تتناسب مع طبيعة المشكلات المعقدة التي يواجهونها في التعليم المعاصر. هذه الأدوات، بحسب الدراسة، لا تقتصر على توفير المحتوى، بل تساهم في إثارة الخيال وإعادة تشكيل زاوية النظر إلى القضايا.
ومن جهة أخرى، تؤكد دراسة Fadli & Iskarim (2024) على أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُنظر إليه كبديل عن التفكير الإبداعي البشري، بل كمحفز أو مصدر إلهام. فالطالب الذي يمتلك مهارات إبداعية أصيلة يمكنه توظيف مخرجات الذكاء الاصطناعي كأفكار أولية يطورها ويُعيد صياغتها بأسلوبه الخاص، مما يُبقي على "الهوية الفكرية" للعمل، ويُعزّز من استقلالية الطالب الإبداعية.
ومع ذلك، فإن الجانب السلبي لا يمكن تجاهله. إذ يرى Bushell (2025) أن الطلاب الذين يعتادون على استخدام الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام الكتابية والإبداعية يُظهرون على المدى المتوسط تراجعًا ملحوظًا في قدراتهم التعبيرية والإنشائية. فبدلًا من ممارسة الإبداع الذاتي، يعتمد الطالب على ما يقدّمه الذكاء الاصطناعي من نصوص جاهزة، مما يُحول عملية "الإنتاج" المعرفي إلى استهلاك آلي يُقوّض القدرة على توليد أفكار نابعة من الذات. ويصف Bushell هذا النمط بأنه "إبداع بالوكالة"، يُفرّغ النشاط الذهني من محتواه ويحوّل الطالب إلى ناقل للأفكار لا مبتكرًا لها، ما قد يؤدي في النهاية إلى "فقدان الصوت الفكري الشخصي" في الأعمال الأكاديمية والفنية.
وبذلك، فإن أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع يتموضع على طيف يتراوح بين التحفيز والتقليد، ويعتمد في النهاية على طريقة الاستخدام. فإذا ما تمّ دمج هذه الأدوات ضمن إطار تعليمي يُعزز التفكير التصميمي والتعبير الذاتي، فإنها تتحول إلى أدوات ثرية تدعم الإبداع. أما إذا تم استخدامها كحلول سريعة لإنجاز المهام، فإنها تُهدد بتقويض جوهر الإبداع نفسه.
ثالثاً: مهارات حل المشكلات: أدوات داعمة ولكن محدودة
يؤكد Doyle (2023) أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُستخدم لتعزيز مهارات حل المشكلات، عبر تقديم سيناريوهات افتراضية تتيح للطالب التفاعل مع بيانات متعددة، وتطوير حلول منطقية. وقد دعم Alvarado-Bravo et al. (2024) هذه الفكرة، مشيرين إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي ساهم في تحسين مرونة التفكير والتحليل البنائي لدى الطلاب.
مع ذلك، تنتقد بعض الأدبيات هذا التوجه، مشيرة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي غالبًا ما تُبنى على أنماط حلول متكررة ومحددة سلفًا، ما قد يُقلل من التجريب والاستكشاف الشخصي في حل المشكلات. كما أن الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في هذا السياق قد يؤدي إلى تراجع قدرة الطالب على مواجهة المواقف الجديدة بشكل مستقل.
رابعاً: الاعتبارات الأخلاقية والتربوية: فجوة بين الإمكانات والتنظيم
تشير دراسة Ali & Elkot (2024) إلى أن غياب أطر تنظيمية واضحة يُعد من أبرز التحديات في استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم. فقد وُثّقت حالات متزايدة من الغش الأكاديمي، وانتحال الأفكار، والاعتماد على النصوص المُولدة آليًا دون فهم أو تحليل.
كما أشار Bushell (2025) إلى أن الأدوات الذكية، رغم فائدتها، قد تُستخدم كمنافذ للتهرب من التعلم الحقيقي إذا لم يتم ضبطها بسياسات صارمة.
من زاوية أخرى، ترى Gawlik-Kobylińska (2024) أن الذكاء الاصطناعي يعمّق من الفجوة الرقمية بين الطلاب، حيث يحظى البعض بفرص أكثر للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بسبب معرفتهم التقنية أو توفر الموارد، بينما يُهمّش آخرون نتيجة النقص في التدريب أو الوصول.
خلاصة
في ضوء ما تقدم، يبدو أن مستقبل مهارات التفكير في زمن الذكاء الاصطناعي ليس محسوماً، بل مرهون بالاختيارات التربوية التي نتبناها اليوم. فالذكاء الاصطناعي، بما يحمله من إمكانات تفاعلية هائلة، لا يُمثل في حد ذاته تهديدًا أو خلاصًا، بل هو أداة محايدة يتوقف أثرها على كيفية استخدامها. فإذا ما وُظّف في بيئات تعليمية واعية، يمكن أن يُصبح شريكًا في تنمية التفكير النقدي، وتوسيع الخيال، وتحفيز حل المشكلات بطرائق غير تقليدية.
لكن في المقابل، إذا تُركت هذه الأدوات تعمل بمعزل عن ضوابط تربوية وأخلاقية، فقد تُسهم في تشويه العلاقة بين الطالب والمعرفة، وتحويل مهارات التفكير إلى ظلال باهتة لخوارزميات جاهزة. وهنا تكمن المفارقة التي يطرحها عنوان الدراسة: هل سنرى طلابًا يُبدعون بالتفكير في عصر الخوارزميات، أم طلابًا تُفكر عنهم الخوارزميات؟
إن مصير مهارات التفكير في هذا العصر ليس قدرًا محتومًا، بل هو مشروع مفتوح للتشكيل، يتطلب قيادة تعليمية رشيدة، وممارسات تربوية تعزز الوعي الرقمي، وتحترم العقل البشري بوصفه مركز التعلم لا هامشه. وعليه، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في "حظر" الذكاء الاصطناعي أو "الانبهار" به، بل في بناء ثقافة تعليمية تُحسن استخدامه، وتُبقي على شرارة التفكير متّقدة في أذهان الطلاب، مهما تطورت الخوارزميات.
المراجع
تعليقات